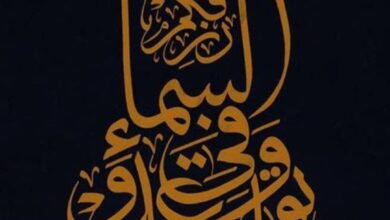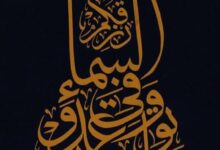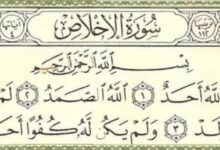في صفحات التاريخ الإسلامي الأولى، يبرز اسم أبي جهل رمزًا للمواجهة العنيدة التي واجهت دعوة الإسلام في بداياتها بمكة. كان اسمه الحقيقي عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي، من سادات قريش وأشراف بني مخزوم، وهو أحد أعيان مكة الذين كانت لهم الزعامة والرأي في دار الندوة قبل بعثة النبي ﷺ.
أصله ومكانته في قريش:
ينتمي عمرو بن هشام إلى بيتٍ من بيوت السؤدد والريادة، فكان والده هشام بن المغيرة سيدًا من سادات قريش، صاحب جاهٍ وكرمٍ وسخاء. ورث عنه ابنه عمرو الفخر والكبرياء، فصار في قومه وجيهاً ذا مكانة، يُستشار في الأمور، وتُسمع كلمته بين رجال مكة. كان يُكنّى قبل الإسلام بـ أبي الحكم لحكمته في الفصل بين الناس عند الخصومات.
من “أبي الحكم” إلى “أبي جهل”:
غير أنّ النبي محمد ﷺ غيّر كنيته من “أبي الحكم” إلى “أبي جهل” بعد أن ظهر منه العناد والغلظة تجاه الحق، وقيامه بتعذيب المستضعفين من المسلمين، ومنهم سمية بنت خياط — أول شهيدة في الإسلام — التي طعنها بحربته حتى فارقت الحياة. قال النبي ﷺ حينها: «هو أبو جهل» أي الجاهل بالحق رغم ظهوره.
صفاته وشكله كما وصفته المصادر:
ذكرت كتب السير أن أبا جهل كان رجلًا ضخمًا جسيماً، عريض الوجه، قوي الصوت، جهوريّ النبرة، تبدو عليه علامات الزعامة. وكان من أكثر الناس حزمًا وصرامة، لا يلين في رأي، ولا يقبل نصحًا إن خالف كبرياءه.
قال ابن كثير في “البداية والنهاية”: «كان أبو جهل من أشراف قريش ورؤسائهم، شديد العداوة للنبي، كثير الأذى للمؤمنين، متكبّرًا متعاظمًا في نفسه».
أما ابن هشام فيروي عن ابن إسحاق قوله: «كان أبو جهل من أعدى الناس لرسول الله ﷺ، حسدًا وبغيًا، وكان يقول: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا: منا نبيّ، فأنّى لنا به؟»، في إشارةٍ إلى حسده لبني عبد مناف لما نالوه من النبوة.
عناده وعداوته للإسلام:
لم يكن أبو جهل خصمًا عاديًا، بل كان زعيمَ المعارضة المكية ضد الإسلام، يخطط ويقود، ويحرّض القبائل على معاداة النبي ﷺ.
عُرف بوقوفه عند الكعبة يصرف الناس عن سماع القرآن، وبمنعه المستضعفين من الدخول في الإسلام، وكان يقول: «إن محمداً يفرّق بين الأب وابنه، والزوج وزوجته».
وفي سيرة ابن هشام، حين جاء النبي ﷺ يصلي عند الكعبة، قال أبو جهل متوعدًا: «لئن رأيت محمدًا يصلي عند الكعبة لأطأنّ عنقه». فلما رآه قائمًا، أقبل نحوه يحمل حجرًا عظيمًا، فلما اقترب وقف فجأة متراجعًا وقد تغيّر وجهه، فقالوا له: ما لك؟ قال: «رأيتُ بيني وبينه خندقًا من نار وهولًا وأجنحة». فنزل قوله تعالى:
﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ﴾ — [العلق: 6]
في دار الندوة وتآمره ضد النبي ﷺ:
حين قرر المشركون قتل النبي ﷺ، كان أبو جهل من أصحاب الرأي في دار الندوة، واقترح أن يأخذ من كل قبيلة رجل ليضربوا النبي ضربة رجل واحد، حتى يتفرق دمه بين القبائل. وقد أشار القرآن إلى هذا المكر في قوله تعالى:
>﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ — [الأنفال: 30]
دوره في بدر ومصرعه:
كان أبو جهل قائد المشركين يوم غزوة بدر، خرج في زهاء ألف مقاتل متعاليًا يقول: «واللات والعزى لا نرجع حتى نرد بدرًا، فننحر الجزر، ونشرب الخمر، وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا أبدًا».
لكنّ نهاية أبي جهل جاءت في تلك المعركة نفسها التي أرادها استعراضًا للقوة. فقد قاتله غلامان من الأنصار هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، فأصاباه بجراحٍ قاتلة.
وعندما رآه عبد الله بن مسعود جريحًا يحتضر، قال له أبو جهل: «لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا رُويعي الغنم!»، فقال له ابن مسعود: «الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله»، ثم قتله.
فلما علم النبي ﷺ بقتله قال: «هذا فرعون هذه الأمة»، كما ورد في صحيح مسلم.
إرثه ورمزيته في التاريخ الإسلامي:
غدا اسم أبي جهل في الذاكرة الإسلامية رمزًا للكِبر والجهل والعناد، لا بمعنى الجهل بالعلم، بل الجهل بالحق رغم ظهوره. وذكرت كتب التفسير أن آياتٍ عدة نزلت فيه، منها قوله تعالى:
>﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾ — [العلق: 9–10]
أما ابنه عكرمة بن أبي جهل، فقد أسلم بعد فتح مكة، وحسُن إسلامه، وكان من الصحابة الكرام الذين حملوا راية الإسلام بعد أبيه، ليبقى في قصتهما درسٌ خالد في تبدّل القلوب من العناد إلى الهداية.
لقد كان أبو جهل صورةً حيّة للتكابر الذي يُعمي عن الحق، وللجهل الذي يلبس لباس القوة والعقل، لكنه يسقط عند أوّل مواجهةٍ مع الحقيقة. فبموته في بدر طويت صفحة من صفحات الجاهلية، وبدأ فجرُ الإسلام يبزغ على أرضٍ طهّرها الله من صوت الكفر والعدوان.
المصادر:
ابن هشام، السيرة النبوية
ابن إسحاق، سيرة رسول الله
ابن كثير، البداية والنهاية
الطبري، تاريخ الأمم والملوك
ويكيبيديا العربية: أبو جهل
موقع موضوع: صفات أبي جهل
موقع المرجَع: حياة أبي جهل وموقفه من الإسلام