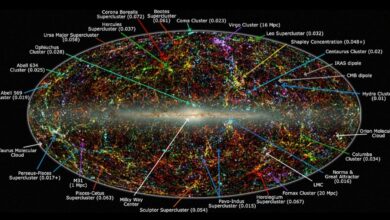منذ فجر التاريخ، ظل الإنسان مشدودًا إلى المستقبل، خائفًا من مجهوله، آملًا في فك طلاسمه، متشبثًا بأي خيط يوصله إلى علم الغيب. ومع تعاقب الحضارات، تشكلت أنظمة معقدة من العرافة والتنجيم، وبرزت شخصيات تدّعي القدرة على كشف المجهول، سواء عبر رموز سماوية، أو طقوس روحية، أو حتى استراق للسمع من عوالم خفية. وبين من يرى فيهم وسطاء للغيب، ومن يعتبرهم مهرجين أو أدوات تضليل، يتجدد الجدل كلما تحققت نبوءة أو راجت توقعات.

في هذا المقال، نقف وقفة علمية وتأملية على هذا الموروث الممتد، نستعرض جذوره في المخطوطات القديمة، موقف الأديان منه، وتحليلًا للظاهرة في العصر الحديث.
✦ الجذور الدينية والميتافيزيقية
يُجمع الإسلام على أن علم الغيب هو لله وحده، لا يشرك فيه أحدًا من خلقه. ففي القرآن الكريم: “قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله”. ومع ذلك، يُشير النص القرآني إلى أن الشياطين قد كانت تسترق السمع من السماء الدنيا، قبل أن تُحجب عن ذلك مع نزول الوحي، فقال تعالى: “وحفظًا من كل شيطان مارد”، مؤكدًا أن ما قد يبلغه الكاهن أو العراف، إنما هو خليط من صدق قليل وكذب كثير.
في الحديث النبوي: “الكاهن يخلط الكلمة بالعدة من الكذب، فيصدقونه”، تأكيد على خطورة تصديق العرافين حتى لو صدقوا مرة، إذ غالبهم يعتمد على التضليل.
أما في الكتاب المقدس، فثمة موقف واضح من العرافة؛ ففي سفر التثنية: “لا يوجد فيك من يمرر ابنه أو ابنته في النار، ولا من يتعاطى العرافة، ولا عائف، ولا متفائل، ولا ساحر، لأن كل من يفعل ذلك مكروه لدى الرب.” وفي سفر دانيال، نرى بروز الرؤى الرمزية والنبوءات المؤقتة التي تُفسر على أنها إشارات مستقبلية، لكنها دومًا تُعزى إلى الله لا إلى بشر.
✦ من ألواح بابل إلى كبد الحيوان
في حضارات ما بين النهرين، برزت أنظمة عرافية مدوّنة على ألواح طينية. أبرزها “إنوما آنو إنليل”، وهي سلسلة من أكثر من سبعين لوحًا يرجع تاريخها إلى حوالي 1600 ق.م، تضم تنبؤات مبنية على رصد الظواهر السماوية، من مثل ظهور القمر أو كسوف الشمس، تُفسر كعلامات على أحداث سياسية أو كوارث: “إذا ظهر القمر الجديد ولم يُرَ، فإن ملك الأرض سيموت.”
أما السومريون، فكانوا يمارسون كهانة الكبد، حيث تُذبح الحيوانات وتُفحص أكبادها بعناية شديدة، إذ يُعتقد أن الكبد يُظهر إشارات مرسلة من الآلهة. كان للكبد خريطة تُقسّم إلى مناطق ترمز لآلهة مختلفة، وكل بقعة غير معتادة أو لون مغاير يُعد نذيرًا.
✦ الموتى يتحدثون في مصر القديمة
في مصر الفرعونية، وُجد ما يُعرف بـ “كتاب الموتى”، أو “الخروج في النهار”، وهو مجموعة من التعاويذ تُقرأ على المتوفى لتأمين عبوره إلى العالم الآخر. فيه نصوص تنبؤية للمصير الأخروي: “إذا وُجد قلبك خفيفًا، تمر إلى الحقول الخضراء؛ وإذا ثقيلاً، تُفترس من الوحش آمِت.” هذا المقطع، وإن لم يكن غيبًا دنيويًا، إلا أنه يكشف عن تصور المصريين لعدالة كونية تُحدد المصير بعد الموت، بأسلوب رمزي قريب من النبوءة.
✦ دلفي… أنفاس الأرض تتكلم
في اليونان، كانت كاهنة دلفي تجلس فوق شق في الأرض ينبعث منه بخار، يدخلها في حالة نشوة تنطق خلالها بأقوال غامضة، يُفسرها الكهنة لاحقًا. من أقوالها الشهيرة ما خاطبت به كروسوس ملك ليديا: “إذا عبرت النهر، ستحطم إمبراطورية عظيمة.” وقد عبر فعلاً… لكنه حطم إمبراطوريته هو. هذا الأسلوب الغامض في التعبير يعكس طبيعة التنبؤات التي تصلح لكل الاحتمالات.
✦ القبّالة وأسرار الحروف
في التقاليد اليهودية، خصوصًا في سفر إشعياء وسفر دانيال، نجد رؤى مستقبلية حول زوال الممالك وظهور المخلّص، غالبها مكتوب بلغة رمزية تعتمد على الأرقام والرموز. أما في القبّالة، فتُمنح الحروف والأرقام طاقة روحية، ويُقال إن من يفك رموز أسماء الله السرية يستطيع أن يدرك الماضي والمستقبل. لكن هذا التصور يُفهم غالبًا بشكل رمزي لا حرفي، مرتبط بـ”الحدس الروحي” لا بالعلم الغيبي المباشر.
✦ من أوراق اللعب إلى أوراق الغيب
ظهرت أوراق التاروت أولاً في القرن الخامس عشر في أوروبا كلعبة، لكنها تحولت في القرن الثامن عشر إلى أداة روحانية. تُقسّم البطاقات إلى رموز تحمل دلالات “نفسية” أو “طاقية”، ويُعتقد أنها تكشف عن احتمالات أو مسارات قادمة، لا أحداث دقيقة. ومن اللافت أن رموز التاروت تأثرت أيضًا بالتصوف اليهودي (القبّالة) وبالرمزية المسيحية، ما يجعلها نظامًا هجينًا بين الميثولوجيا والحدس.
✦ عندما يتكلم العلم
علم النفس الحديث يُرجع العرافة إلى ظواهر عقلية مثل تأثير فورير، حيث يميل الناس إلى تصديق أوصاف عامة على أنها دقيقة، وكذلك الانحياز التأكيدي، حيث نميل لتذكر ما يوافق توقعاتنا وننسى العكس. أما الباراسيكولوجيا، فهي حقل لم تثبت فرضياته تجريبيًا، رغم عشرات الدراسات حول الإدراك المسبق والاستبصار.
العلوم الطبيعية من جهتها لم تجد دليلًا على أن الدماغ البشري قادر على تجاوز الزمن. ورغم أن “الحدس” يُعتبر ظاهرة عقلية حقيقية، إلا أنه لا يُقاس على الغيب، بل على سرعة معالجة المعطيات.
✦ قراءة في التنبؤات الحديثة
في العقود الأخيرة، تصدرت أسماء مثل ليلى عبد اللطيف، ومايا هزيم، وميشيل حايك، المشهد الإعلامي بتنبؤاتهم. تحليل مضمون توقعاتهم يُظهر ميلًا إلى التعميم: “اغتيال شخصية بارزة”، “حدث يهز المنطقة”، “كارثة طبيعية”… وهي توقعات تحتمل التحقق في أي مكان وزمان، ما يُضعف قيمتها العلمية.

ومع ذلك، حين تصدق إحدى التوقعات بدقة، تكثر التفسيرات: من التوفيق العشوائي، إلى المعلومات المسبقة، أو حتى توظيف بعض الأجهزة الاستخباراتية لتوجيه الرأي العام من خلال هؤلاء الأشخاص. نظرية المؤامرة هنا ليست مستبعدة تمامًا، خاصة حين تكون التنبؤات موجهة سياسيًا أو تحمل تحذيرات استراتيجية.
وهكذا، يتضح أن التنبؤ بالغيب لم يكن يومًا حكرًا على ثقافة واحدة، ولا كان في جوهره علمًا دقيقًا. ما بين رموز كهنة بابل، وأبخرة دلفي، وأوراق التاروت، تظل العرافة لغة شِعرية أكثر منها كشفًا للحقائق. أما المستقبل، فيبقى – كما كان دومًا – سرًا إلهيًا، لا يُفتح إلا بقدَر.