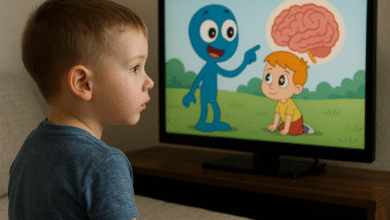في تاريخ الأمم، لا يُرفع العلم عبثًا، ولا تُختار ألوانه مصادفة. فكل راية هي شهادة ميلادٍ لدولة، ومرآةٌ لهويتها، ورمزٌ لاستقلالها أو تبعيتها. ومن بين أكثر القصص دلالةً في شمال إفريقيا، تبرز حكاية الأعلام الثلاثة: علم المغرب الأقدم والأرسخ، علم الجزائر الذي وُلد من رماد الاستعمار سنة 1962، وعلم “جبهة البوليساريو” الذي استُنسخ في سبعينيات القرن الماضي على يد الجزائر، ليكون أداة في مشروع تعطيل نهضة الجار الغربي.
منذ قرونٍ، كان اللواء الأحمر يرفرف فوق القصور والأسوار المغربية، رمزًا للدولة العلوية التي بسطت نفوذها على البلاد منذ القرن السابع عشر. ولما صدر الظهير الشريف في 17 نونبر 1915 في عهد السلطان مولاي يوسف، أضيفت النجمة الخماسية الخضراء إلى الحقل الأحمر، فأصبح العلم كما نعرفه اليوم؛ دلالة على السيادة والاستمرارية، ورمزًا للوحدة والبيعة والشرعية التي لم تنقطع يومًا.
أحمرُه من دماء المجاهدين والملوك الذين ذادوا عن الأرض، وخضرته من روح الإسلام وعمق الانتماء. إنه علمٌ لم يُصنع في قاعات السياسة الحديثة، بل نبت من جذور الدولة نفسها، من عمق الصحراء إلى الأطلنطي، ومن فاس إلى الداخلة.
أما الجزائر، فقد كان تاريخها مختلفًا. لقرونٍ طويلة كانت إيالة عثمانية، ترفرف فوقها الراية العثمانية لا الوطنية. ثم، وبعد قرنٍ وثلاثين من الاحتلال الفرنسي، وُلدت الدولة الحديثة سنة 1962، واعتمدت علمها الحالي في الثالث من يوليوز من السنة نفسها: شطران أخضر وأبيض، وهلال ونجم أحمران، في توليفة رمزية تعكس الإسلام والهوية الوطنية الجديدة.
غير أن هذا العلم لم يكن امتدادًا لدولةٍ قائمة، بل إعلان ولادة بعد فراغٍ سيادي طويل. فالهويّة الجزائرية الحديثة تشكّلت حديثًا، ولم يكن لها إرث سيادي متصل كما هو الحال في المغرب.
لكن المفارقة التاريخية أن المقاومة الجزائرية نفسها، خلال حرب التحرير، كانت ترفع العلم المغربي، وتتلقى دعمها المالي والعسكري واللوجيستي من المغرب. لقد كانت أرض المغرب مهدًا للمجاهدين الجزائريين، وممرًّا لأسلحتهم، ومأوى لقياداتهم.
مدينة وجدة تحديدًا كانت قاعدة خلفية للثورة الجزائرية، فيها خُطِّطت العمليات، ومنها مرّ السلاح القادم من فاس والدار البيضاء، وفيها استقرّ آلاف اللاجئين والمقاتلين. شوارعها مازالت شاهدة على تلك المرحلة، وأزقتها تحفظ أسماء المقاومين الذين آمنوا أن حرية الجزائر وكرامة المغرب قضية واحدة.
ولذلك كان مؤلمًا أن تتحوّل اليد التي احتضنت الثورة إلى هدفٍ للعداء بعد الاستقلال، وأن تُنسى راية المغرب التي كانت ترفرف إلى جانب المقاومين في الجبال والسهول.
ثم جاءت الراية الثالثة، التي رفعتها “جبهة البوليساريو” سنة 1976 بدعم وتمويل ورعاية من الجزائر، بعيد انسحاب إسبانيا من الصحراء المغربية. فكانت الألوان مختارة بعناية لا تخفى على ذي بصيرة: الأسود والأبيض والأخضر، والمثلث الأحمر، والهلال والنجم الحمران؛ مزيج يعكس بوضوح استنساخًا شبه تام لرمزية العلم الجزائري، امتنانًا وعرفانًا بالدعم الذي وفّرته الجزائر للجبهة منذ تأسيسها.
لقد صُنِع هذا العلم في سياقٍ سياسي لا رمزي؛ وُلد من رحم المناورة لا من جذور الأرض، إذ لم تكن الصحراء عبر التاريخ كيانًا منفصلاً عن الدولة المغربية، بل جزءًا منها كما تثبته وثائق البيعة ومراسلات السلاطين وشهادات الأمم نفسها.
وهكذا تحوّلت الأعلام الثلاثة إلى رموز لصراعٍ أبعد من الألوان:
فالعلم المغربي يمثل شرعية التاريخ والدولة والهوية،
والعلم الجزائري يرمز إلى ولادة جديدة بعد الاستعمار،
وعلم البوليساريو ليس سوى ظلٍّ لذلك الوليد، استُنسخ ليكون أداة لعرقلة الجار، ومسمارًا في عجلة التنمية المغربية التي تسير بثبات نحو المستقبل.
لقد كانت الجزائر يومًا تُقاتل تحت رايةٍ مغربية حين لم تكن لها راية، لكنها اليوم تصنع رايةً وهمية لتشعل نار الفتنة في الجوار.
ولأن التاريخ لا يُزوّر، فإن وجدة وفاس والرباط تحفظ شهادتها: أن المغرب كان ومازال بيتًا مفتوحًا للأشقاء، وأن رايته الحمراء كانت رمزًا للمقاومة لا للعدوان.
في خطابٍ للملك محمد الخامس سنة 1956 قال مخاطبًا الشعب الجزائري:
> “إن استقلال المغرب لن يكون كاملاً إلا باستقلال الجزائر، فنحن وإياهم جسد واحد لا تنفصل أجزاؤه.”
وهو التصريح الذي وثقته جريدة Le Monde الفرنسية آنذاك، مؤكدةً أن المغرب فتح حدوده لتمرير السلاح وتدريب المقاومين الجزائريين في أراضيه.
كما يورد المجاهد أحمد بن بلة في مذكراته المنشورة سنة 1980 قوله:
> “لقد كان المغرب سندنا الأول في الثورة، منه عبر السلاح، ومن وجدة انطلقت عملياتنا، وكان الملك محمد الخامس لا يتردد في دعمنا سياسيًا وماليًا.”
بل إن جبهة التحرير الوطني الجزائرية نفسها كانت تتخذ من مدينة وجدة مقراً لقيادتها، ومنها انطلقت بياناتها الأولى، قبل أن تُعلن الاستقلال سنة 1962. ومازالت المدينة تحتفظ بمقابر شهداء الثورة الجزائريين، لتشهد على عمق الأخوّة التي انقلبت لاحقًا إلى خصومة مؤسفة.
وهكذا، تبقى حكاية الأعلام الثلاثة مرآةً لحقيقةٍ مرة:
أن راية المغرب، التي كانت في يومٍ من الأيام مظلةَ المقاومة الجزائرية، أصبحت اليوم هدفًا لحربٍ رمزية وسياسية من جارٍ نكث العهد ونسي التاريخ.
لكن، وكما بقيت الراية المغربية خفّاقة عبر القرون، ستظل ترفرف بالسيادة والوحدة، لا تُمزّقها الرياح، ولا تطفئها المؤامرات.