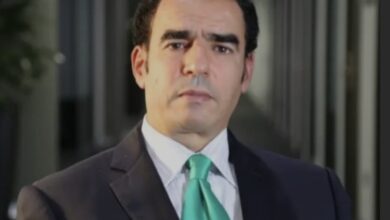في زمن التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وتعدد ساحات النزاع في الإقليم العربي، تعود إلى الواجهة معاهدة الدفاع العربي المشترك، تلك الوثيقة التي وُلدت من رحم التطلعات القومية والوحدة المصيرية، لكنها بقيت حبيسة الأدراج، رغم مرور أكثر من سبعة عقود على توقيعها.
المفارقة أن هذه المعاهدة، التي من المفترض أن تمثل الحد الأدنى من التضامن العربي في مواجهة العدوان الخارجي، لم تُفعَّل ولو مرة واحدة بشكل عملي، رغم أن العالم العربي شهد خلال هذه العقود ما يكفي من الأزمات والصراعات والتدخلات العسكرية، التي كان من شأنها أن تُحرّك أية آلية دفاع جماعي قائمة بين الدول.
معاهدة الدفاع العربي المشترك وُقعت عام 1950، في لحظة تاريخية كانت مشحونة بالأمل والرغبة في بناء نظام عربي متكامل قادر على مجابهة التحديات الخارجية. ولئن كانت الصيغة القانونية متقدمة نسبيًا في نصوصها، فإن الظروف السياسية منذ الخمسينيات وحتى اليوم كشفت عن فجوة واسعة بين التنظير والتنفيذ.
لم يكن الخلل في النصوص، بل في غياب الإرادة السياسية وانعدام التوافق الاستراتيجي بين الدول الموقعة، مما جعل من هذه المعاهدة رمزًا للوحدة غير المنجزة، ومثالًا على العجز المؤسساتي في إدارة الأمن العربي.
من أبرز العوامل التي وقفت عقبة أمام تفعيل المعاهدة:
تباين المصالح القومية والاصطفافات الإقليمية: لم تشهد الدول العربية في تاريخها الحديث لحظة إجماع حقيقي على مفهوم “العدو المشترك”، بل على العكس، تحوّلت بعض الأزمات الداخلية إلى ساحات صراع عربي-عربي، مما نسف الثقة في إمكانية بناء جبهة أمنية موحدة.
ضعف البنية العسكرية المشتركة: لم يتم تأسيس قوة عربية دائمة أو غرفة عمليات فعّالة تخطط وتنفذ عمليات دفاع جماعي. اللجنة العسكرية التي نصت عليها المعاهدة بقيت شكلية، تعقد اجتماعات محدودة لا تسفر عن قرارات مُلزمة.
التدخلات الدولية: الواقع السياسي العربي كثيرًا ما تحكمه تحالفات خارجية وقواعد أجنبية، مما يُقيد حرية القرار السيادي في بعض الدول، ويجعلها تتردد في الانخراط في ترتيبات دفاع جماعية قد تُصنّف على أنها “مواقف معادية” لحلفاء خارجيين.
من المثير للسخرية أن المعاهدة، رغم نبل أهدافها، لم تتمكن من صياغة محددات واضحة لما يشكل تهديدًا جماعيًا يستدعي التفعيل. فهل الاعتداء على دولة عضو من طرف قوة غير عربية يستوجب الرد؟ هل الاعتداء السيبراني أو الاقتصادي يُصنّف ضمن المخاطر التي تستدعي التفعيل؟ لا توجد إجابات عملية، بل مجرد نصوص قانونية فضفاضة تُترك لتقدير الدول، التي غالبًا ما تختلف حول التقييمات.
لقد مرّ العالم العربي بأحداث جسام، من الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، إلى غزو العراق للكويت عام 1990، ثم الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة، دون أن تُفعّل المعاهدة. وحتى حين تعرّضت عاصمة عربية لهجوم مباشر، كما حدث في العدوان على الدوحة مؤخرًا، لم يُستدعَ البند المتعلق بالدفاع المشترك، بل سُجّلت المواقف التضامنية في البيانات فقط.
إن صمت البنادق العربية في وجه المعتدين لا يعكس فقط فشل معاهدة، بل يعكس غياب مشروع أمني عربي موحد، قادر على توحيد الرؤية وتنسيق الردود. فالمعادلة الأمنية في المنطقة باتت تُدار من خارج الإقليم، في ظل غياب مرجعية استراتيجية عربية موحدة.
أمام هذا الواقع، لا يكفي البكاء على وثيقة غير مفعّلة، بل المطلوب اليوم مراجعة شاملة:
أولًا: إعادة تعريف التهديدات وفقًا لواقع المنطقة الحديث، بما يشمل التهديدات التقليدية وغير التقليدية.
ثانيًا: تأسيس هيئة عسكرية عربية مشتركة تعمل تحت مظلة الجامعة العربية بقرارات تنفيذية، وتتمتع بميزانية مستقلة.
ثالثًا: ضبط آلية اتخاذ القرار في مجلس الدفاع المشترك لضمان سرعة الاستجابة، دون أن تُشلّ المبادرات بسبب الخلافات السياسية.
رابعًا: تعزيز الدبلوماسية الدفاعية العربية مع الأطراف الدولية المؤثرة لضمان دعم سياسي وقانوني لأي تحرك دفاعي جماعي.
معاهدة الدفاع العربي المشترك تمثل وثيقة سياسية وقانونية مهمة، لكنها لم تُكتب لتبقى رمزية. في زمن تتساقط فيه الخطوط الحمراء، ويُعاد رسم خرائط النفوذ بالقوة، لا بد من أن تتجاوز الدول العربية منطق الحذر والسيادة المطلقة في قضايا الدفاع، نحو بناء منظومة أمن جماعي حقيقية. فالأمن لم يعد ترفًا، بل شرطًا لبقاء الدولة العربية نفسها في مواجهة الأخطار المتزايدة.